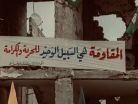برّ الوالدين في سيرة أهل البيت عليهم السلام

الشيخ حسن أحمد الهادي
سُئل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا». قال: ثمَّ أيٌّ؟ قال: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قال: ثمَّ أيٌّ؟ قال: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(1).
• أولاً: أغراض التشريع الإسلاميّ
لا شكّ في أنّ التشريعات الإسلاميّة تستند إلى أسس ترتبط بالمصالح والمفاسد. وقد لحظت هذه التشريعات الصادرة عن الخالق العالِم والحكيم طبيعة التكوين الخَلقيّ للإنسان، والقوى الداخليّة المغروسة في النفس الإنسانيّة. لذا، فهي تستهدف الحفاظ على الاجتماع البشريّ بإيجاد منظومة من التشريعات الحقوقيّة والقيم والآداب، وضبط الكيان الأسريّ والاجتماعيّ، ونسج العلاقات الإيجابيّة الفاعلة والحيويّة بين جميع الأفراد، بنحو يجعل العيش المشترك بينهم محقّقاً لأهداف الحياة الطيّبة. لتحقيق هذه الغاية، قدّم الإسلام تشريعات إلهيّة كاملة ونموذجيّة، منها ما هو خاصّ بمكوّن الأسرة الأوّل المتمثّل بالوالدين. قال الله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا﴾ (الإسراء: 23-24) . فالملاحظ أنّ القرآن الكريم قد أسّس مجموعةً من الأصول والقواعد التربويّة:
1. أصل الإحسان: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾. والإحسان في الفعل يقابل الإساءة، وهذا بعد التوحيد لله من أوجب الواجبات.
2. قواعد الخطاب مع الوالدين: ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، ﴿وَلاَ تَنْهَرْهُمَا﴾، ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً﴾. وقد جاءت قواعد الخطاب هذه مخصّصة بحالة الكِبر في السنّ بوصفها أشقّ الحالات التي تمرّ على الوالدين، فيشعران فيها بالحاجة إلى إعانة الأولاد لهما وقيامهم بواجبات حياتَيهما التي يعجزان عن القيام بها. وتأتي كلمة «أفّ» المنهيّ عنها في هذا السياق لما تحمله من دلالة على الضجر والانزجار، وكذا «النهر»، وهو الزجر بالصياح ورفع الصوت والإغلاظ في القول.
3. خفض الجناح: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾، وهو كناية عن المبالغة في التواضع والخضوع قولاً وفعلاً، وهو مأخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف أمّه لتغذيته، لذا، قيّده بالذلّ، وهذا دأب أفراخ الطيور إذا أرادت الغذاء من أمّهاتها.
4. الدعاء لهما: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً﴾. أي اذكر تربيتهما لك صغيراً، وادع الله سبحانه أن يرحمهما كما رحماك وربّياك صغيراً(2).
• ثانياً: حقّ الأب وبرّه
لقد وضع أئمة أهل البيت عليهم السلام قواعد تربويّة تحدّد حقوق الأب وطرق التعامل معه وبرّه واحترامه وتقديره. روي عن الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام قوله: «... وإنّ للوالد على الولد حقّاً؛ فحقّ الوالد على الولد أن يطيعه في كلّ شيء إلاّ في معصية الله سبحانه»(3)، وعن الإمام السجّاد عليه السلام : «وحقّ أبيك أن تعلم أنّه أصلك وأنّك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوّة إلّا بالله»(4). وقد وصف الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام برّ الوالد لبعض بنيه بالتحفة الكبيرة، بقوله عليه السلام : «يا بنيّ، إنّ الله رضيني لك ولم يرضك لي، فأوصاك بي ولم يوصني بك، عليك بالبرّ فإنّه تحفة كبيرة»(5).
إنّ دور الأب لا يمكن تجاهله، لإسهامه الأصيل في مجال صياغة تربية الابن وبنائه القيميّ، فالولد بضعة من أبيه؛ يرث أخلاقه كما يرث صفاته الجسديّة والعقليّة، مضافاً إلى إحاطته بشعور العزّة والحماية والصيانة له من والده، والذود عنه. وبذلك، يكون أداء حقّ الوالد جزءاً بسيطاً من ردّ الجميل، وهذه السمة تتّضح في آية الإحسان. وبحسب تعبير الإمام السجّاد عليه السلام في رسالة الحقوق، فإنّ الأب يمثّل الأصل، والابن الفرع؛ فهو أصله ولولاه لم يكن. وقد أمضى حياته وشبابه وأفنى عمره بكدّ واجتهاد للحفاظ على أسرته وتأمين الحياة الهانئة لأولاده. وهذا ما يلزم الابن بالشكر الدائم على هذه النعمة.
• ثالثاً: حقّ الأمّ وبرّها
إنّ التربية وظيفة بنيويّة وتغييريّة موضوعها الإنسان، ويشارك المجتمع في تأسيس مبانيها وأسسها وترسيخها وترشيدها. وتبرز الأمّ في مقدّمة العناصر المؤثّرة في التربية بوصفها مصدر الحنان والعاطفة، ومركز التوجيه والحرص والعناية بكلّ حاجيات الأبناء. تبدأ هذه العلاقة بينهما من حين انعقاد النطفة، فقد جاء في رسالة الحقوق قول الإمام زين العابدين عليه السلام : «وأمّا حقّ أمّك، فأن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحملُ أحد أحداً، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً»(6). وتتوثّق هذه العلاقة حين يولَد الطِّفل، بحيث تكون الأمّ أوّل فردٍ يتواصل معه بنحو مباشر، وهذه العلاقة لا تؤثِّر فقط في مجال تلبية احتياجاته، بل أيضاً في حالاته النفسيّة والعاطفيّة. ويُستفاد من جملةٍ من الروايات أنّ الأمّ تبرز عواطفها تجاه ولدها أكثر من الأب، وتحرص أكثر على تكامله ونموّه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «دعوة الوالدة أسرع إجابة». قيل: يا رسول الله، لم ذاك؟ قال: «هي أرحم من الأب... وبرّ الوالدة على الوالد ضعفان»(7) ، وهذا يكشف عن أهمّية دور الأمّ في نموّ الطِّفل واستقراره.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قيل: يا رسول الله، ما حقّ الوالد؟ قال: «أن تُطيعه ما عاش». قيل: وما حقّ الوالدة؟ فقال: «هيهات هيهات، لو أنّه عدد رمل عالج، وقطر المطر أيّام الدنيا، قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها»(8).
• رابعاً: سيرة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام في برّ الوالدين
لقد كثرت الشواهد والإرشادات في سيرة أهل البيت عليهم السلام في تأسيس علاقات البرّ والعِشرة الحسنة مع والديهم، فقد روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور قبر أمّه في الأبواء، فلمّا مرّ في واقعة الحديبية على قبرها، وقف عندهُ وبكى عليها، وبكى المسلمون لبكائه(9).
ومنها أنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ والدتي بلغها الكبر، وهي عندي الآن، أحملها على ظهري، وأُطعمها من كسبي، وأميط عنها الأذى بيدي، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياءً منها وإعظاماً لها، فهل كافأتها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا، لأنّ بطنها كان لك وعاءً، وثديها كان لك سقاءً، وقدمها لك حذاءً، ويدها لك وقاءً، وحجرها لك حواءً، وكانت تصنع ذلك لك وهي تمنى حياتك، وأنت تصنع هذا بها وتحبّ مماتها»(10).
وهذا الإمام السجّاد عليه السلام يؤسّس في دعائه في الصحيفة السجّاديّة للعلاقة الوجدانيّة العميقة بأهله بقوله: «اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرّهما برّ الأمّ الرؤوف، واجعل طاعتي لوالديّ وبرّي بهما أقرّ لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن»(11). وبهذا، يتّضح واجب الدعاء لهما، فقد روي عن معمّر بن خلاد قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : أدعو لوالدَي إذا كانا لا يعرفان الحقّ؟ قال عليه السلام : «ادع لهما وتصدّق عنهما، وإن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنّ الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق»(12). وكان الإمام زين العابدين عليه السلام بارّاً بأمّه، وهو مع ذلك لا يأكل معها في صحفة واحدة، فقيل له: إنّك من أبرّ الناس بأمّك، لماذا لا تأكل معها في صحفة واحدة؟ فقال: أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليها فأكون قد عققتها»(13). علماً بأنّها كانت مربّيته وليست أمّه، لأنّ أمّه السيّدة شاهزنان بنت يزدجرد ملك الفرس كانت قد توفّيت وهي تلده.
كما ورد في العديد من الأخبار أنّ الإمام السجّاد عليه السلام بكى على أبيه الحسين عليه السلام ، كما روى ابن قولويه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «بكى عليّ بن الحسين على أبيه حسين بن عليّ L عشرين سنة أو أربعين سنة، وما وُضع بين يديه طعام إلّا بكى على الحسين حتّى قال له مولى له: جُعلت فداك يا ابن رسول الله، إنّي أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: «إنّما أشكو بثّي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلّا خنقتني العبرة لذلك»(14).
وروى الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام في وصفه لأمّه، قال: «كانت أمّي ممّن آمنت واتّقت وأحسنت، والله يحبّ المحسنين»(15). وفي هذا غاية البرّ والإحسان، إذ ما يصدر عن المعصوم عليه السلام يعبّر عن الواقع وحقيقة الأمر.
• خامساً: آثار برّ الوالدين
ذكرت كتب الحديث المعتبرة آثاراً ماديّة ومعنويّة مختلفة لبرّ الوالدين، نكتفي بذكر مواردها اختصاراً، منها: دفع الفقر، وزيادة الرزق، وطول العمر، وتخفيف سكرات الموت، ورضى الله، ومغفرة الذنوب، وتخفيف الحساب يوم القيامة، والفوز بالجنّة. وجاء في الأحاديث أيضاً أنّ نظر الولد الرّحيم إلى والديه، يفتح له أبواب رحمة الله عزّ وجلّ، ويكتب له أجر الحجّ المبرور. وقد ذكر ثواب عتق رقبة للابن في حال رضى الوالدين عنه. وقد نُقل عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الكافي أنّه لكلّ إحسان إلى الوالدين، ولكلّ صلاة وصدقة تُهدى للوالدين المتوفّين، أجر مضاعف يعود على الابن(16).
يتّضح من كلّ ما سبق أنّ برّ الوالدين ليس واجباً فحسب، بل هو طريق لنيل رضى الله وفتح أبواب رحمته في الدنيا والآخرة.
*باحث وأستاذ في الحوزة العلميّة، لبنان.
1. بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 97، ص 11.
2. يراجع: الميزان في تفسير القرآن، العلامة الطبطبائي، ج 13، ص 16-17.
3. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 19، ص 365.
4. رسالة الحقوق، الإمام زين العابدين عليه السلام ، حقّ الأب.
5. بحار الأنوار، مصدر سابق، ج 75، ص 136.
6. رسالة الحقوق، مصدر سابق، حقّ الأمّ.
7. المحجّة البيضاء، الفيض الكاشاني، ج 3، ص 435.
8. عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الإحسائي،ج 1، ص 269.
9. الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج 1، ص 94.
10. مستدرك الوسائل، المحقق النوري، ج15، ص180، ح17932.
11. الصحيفة السجّاديّة للإمام زين العابدين عليه السلام ، ص 126.
12. الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص 159.
13. ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج 3، ص 97.
14. كامل الزيارات، ابن قولويه القمي، ص 107.
15. الكافي، مصدر سابق، ج 1، ص 472.
16. المصدر نفسه، ج 2، ص 159.