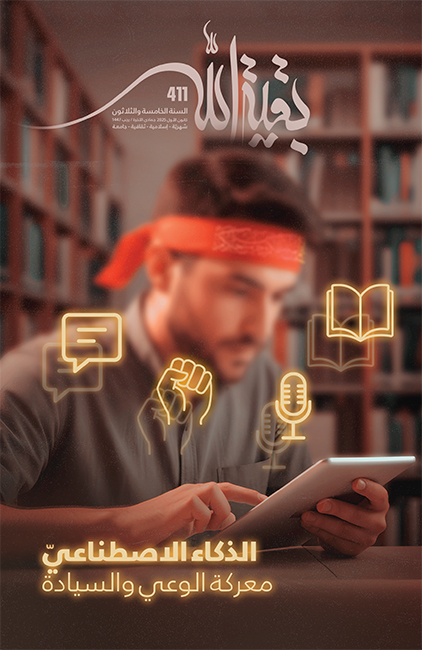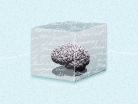أخلاقنا | لا تظنّوا بالآخرين سوءاً*

السيّد الشهيد عبد الحسين دستغيب قدس سره
تخيّل أنّ رجلاً عاد من عمله وهو يحمل في نفسه غصّة، لمجرّد أنّه رأى صديقه يرافق شخصاً يبغضه، أو لأنّ صديقه لم يجبه على اتّصاله كما كان يتوقّع. في داخله، بدأ الوسواس ينخر: «لماذا؟ هل هو متعمّد؟ هل ثمّة شيء أجهله؟»، حتّى أصبح وهمه أمراً واقعاً لديه، وبدأ يعامل صديقه على أساس أنّه خائنٌ، فكوّن بذلك ظنّاً لا حقيقة، وأخذ من الظّن الجانب السيّئ المظلم، بينما الواقع مختلف تماماً.
• معنى سوء الظنّ
كلّ قول وفعل يصدران عن شخص فهما قسمان:
1. وضوح حُسن الفعل: تارة يكون حُسن ذلك الفعل والقول وسلامة نيّة صاحبه، أو عدم سلامتها، واضحين تماماً ويقيناً، بحيث لا يُحتمل خلاف ذلك، كأن يرى إنسانٌ بأمّ عينه شخصاً آخر يشرب من زجاجة، ويتيقّن أنّ ما فيها خمر، وهو يشربه مختاراً من دون أيّ إكراه أو اضطرار. أو أن يبقى شخص مع آخر من الظهر إلى الغروب ويذكّره بالصلاة ثمّ لا يصلّي. وبشكل عام، كلّما كان قُبح قول الشخص أو عمله وسوء نيّته واضحين تماماً، ولا مجال أبداً لاحتمال الحُسن والصحّة، يجوز للآخر أن يُسيء الظنّ به، ويُوسّع في قلبه مكاناً للاعتقاد بسوئه.
2. عدم وضوح حُسن الفعل: وتارة لا يمكن اليقين بحُسن فعله أو قُبحه، ولا بحُسن نيّته أو سوئها، وكلٌّ من الحُسن والسوء محتمل.
مثلاً: شممنا رائحة الخمر من فم شخص، فهنا، يُحتمل أن يكون شارب الخمر عالماً عامداً، ويُحتمل أن يكون شربه نسياناً، أو جهلاً بأنّه خمر، أو أنّ شخصاً أجبره على شربه. ومثل ذلك ما إذا كنّا مع شخص من الظهر إلى الغروب ولم يُصلِّ، واحتملنا أنّه لم يُصلِّ عمداً، واحتملنا كذلك أنّه لم يُصلِّ نسياناً.
وكذلك، إذا ما قال جماعة إنّ فلاناً ارتكب فعلاً قبيحاً، يُحتمل أن يكون كلامهم صحيحاً، ويُحتمل أيضاً أن يكون خطأ، أو أنّهم سمعوا ذلك من شخص مغرض وصدّقوه ونقلوه.
بشكل عام، كلّ قول وفعل يصدران من مسلم، فنسمع قوله أو نرى فعله، ويُحتمل أن يكونا صحيحين لا فاسدين، فحمله على الفساد والاعتقاد بذلك حرام، إلى حدّ أنّه لو أخبر شخصٌ عادلٌ بقُبح فعل شخص آخر، فلا ينبغي قبول ذلك والاعتقاد به، بل يجب أن تقول: لعلّ الأمر اشتبه عليه، أو سمعه من جماعة فحصل له الظنّ من كلامهم؛ لأنّ السماع ظنٌّ مهما بلغ القائل ثقةً. فلا يصح أن يكون كلام العادل سبباً لإساءة الظنّ بمسلم.
• الحمل على الفساد في الأمور العاديّة
إنّ موارد سوء الظنّ في الحياة اليوميّة كثيرة، نذكر منها موارد هي محلّ ابتلاء بشكلٍ عام. مثلاً: يرى شخصٌ رجلاً مع امرأة، فيحمل ذلك على الفساد، أو أنّه يجد زوجته تتحدّث مع شخصٍ أجنبيّ، فيُسيء الظنّ بها من دون أيّ تحقيق. أو يرى اثنين يتحدّثان سرّاً، فيتخيّل أنّهما يستغيبانه، فيُسيء الظنّ بهما، أو يحتمل لدى حديث شخص أنّه يُلمّح إليه ويُكنّي عنه، وهدفه من هذا الحديث الطعن فيه، فيُسيء الظنّ بهذا الشخص.
• ما يخالف التوقّع ليس سبباً لسوء الظنّ
من يتوقّع من شخص آخر أن لا يصدر منه ما هو خلاف رغبته، قد يُسيء الظنّ به إذا صدر منه خلاف ما يتوقّع، فيُبتلى بذنب سوء الظنّ. وغالباً ما يكون ذلك سبباً للعداوة والحقد والحسد والذنوب الأخرى.
مثلاً: يتوقّع شخص من آخر أن يُحسن إليه، ولم يُعطه شيئاً، أو أنّه لم يُعطه بمقدار ما كان يتوقّع، فيُفسّر ذلك بالبخل أو بهدف شيطانيّ آخر، ويُسيء الظنّ به. أو طلب منه قرضاً أو استعارة شيء فلم يُعطه، فيُسيء الظنّ به لذلك. أو طلب نصرته في أمر فلم ينصره بالرغم من استطاعته، فأساء الظنّ به وعدّه إنساناً سيّئاً، مع أنّه كان باستطاعته أن يحمله على الصحّة ويقول: لعلّه في الحقيقة لا يستطيع، وأنا لا أعلم، أو أنّه توقّع من شخص أن يحترمه ويُكرمه ولم يفعل؛ فلم يبتدئه بالسلام مثلاً، أو لم يقم له إجلالاً، أو لم يمدحه، فيُسيء الظنّ به، مع أنّه من المحتمل أن لا يكون الآخر منتبهاً إليه، أو أنّه ألقى عليه تحيّة السلام ولم يسمع الشخص الأوّل، وربما توقّعه من الأساس في غير محلّه.
السبب الأصليّ لهذا النوع من سوء الظنّ هو حبّ الدنيا، والعلاقة الشديدة بالشهوات وشؤون الحياة الماديّة؛ فلذلك، نجد أنّ سوء الظنّ هذا شائع بين الناس، بل يندر الشخص الذي يجتنب هذا الذنب ويتّقيه.
• منهم من يلمزك في الصدقات
من هنا، جاء في الحديث أنّ الإمام الصادق عليه السلام يقول إنّ أكثر من ثلثَي الناس مبتلون بهذا الذنب، كما سيأتي. وقد أُشير إلى هذا النوع من سوء الظنّ في القرآن المجيد، بحيث يقول تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ (التوبة: 58).
بعض المسلمين بحسب الظاهر، إمّا لأنّهم ليسوا مستحقّين ماليّاً، أو لأسباب أخرى، لم يُعطِهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً من الصدقات، وكان ذلك خلاف توقّعاتهم ورغباتهم، فأساؤوا الظنّ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغضبوا منه، ورأوا أنّ عمله ليس مناسباً، والحال لو أنّهم رأوا أن توقّعاتهم في غير محلّها، ورضوا بما أعطاهم الله، لقنعوا وما سخطوا من تقسيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما ابتُلوا بهذا الذنب الكبير. كما يقول تعالى في الآية التالية: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ (التوبة: 59).
أيها القارئ العزيز، لأجل تصديق كلام الإمام عليه السلام، تأمّل قليلاً في حالك وحال سائر المسلمين، لترى أنّنا جميعاً كذلك، أي أنّنا نرضى عن الله حين يُعطينا وفق رغباتنا النفسيّة، أمّا إذا لم يرَ مصلحتنا في ذلك ولم يُعطنا، أو رأى أنّ مصلحتنا في البلاء وما لا يُريح النفس، فعندها نغضب. وبمستوى آخر، نحن نرضى عن الناس عندما يعاملوننا بما يُطابق رغباتنا، وإذا صدر منهم ما يُخالفها، نُسيء الظنّ بهم ونسخط عليهم. فحيث إنّ علاقتنا بالشهوات النفسيّة والرغبات الدنيويّة شديدة، وحيث إنّه لم يستطع أيّ إنسان على الإطلاق أن يُحقّق رغباته في الدنيا -ولن يصل- فلذلك نحن نُسيء الظنّ دائماً بالله والناس، ونظلّ نعتب ونشكو.
• توقّع استجابة الدعاء فوراً
من مصاديق سوء الظنّ بالله تعالى: مسلم يدعو الله ويطلب منه حاجته، ولأنّه يتوقّع استجابة دعائه فوراً، فإذا لم تتحقّق رغبته يسخط على الله، ويعدّ ذلك إخلافاً بالوعد، ويُسيء الظنّ به تعالى. في حين لو أنّه تنبّه إلى شروط الاستجابة، التي من جملتها أن يكون في ذلك مصلحة، وما أكثر الطلبات التي يطلبها الإنسان، ولكنّها في الواقع مضرّة له وهو لا يعلم، لو أنّه تنبّه لذلك، لأساء الظنّ بنفسه بدلاً من إساءة الظنّ بالله، ولأدرك أنّ توقّعه في غير محلّه.
وهذه الحالة غالباً ما تقترن بالقنوط واليأس من رحمة الله، وقد ثبُت في كتاب الذنوب الكبيرة أنّ عدم الأمل بالله من الكبائر.
ينشأ سوء الظنّ هذا بسبب العلاقة بمشتهيات النفس، وعدم الوصول إلى الأمنيات، وضغط البلايا والمنغّصات، ومواجهة المصائب.
إنّه بذلك أساء الظنّ بالله. وعلى الرغم من أنّه لا يكون عندها كافراً ومرتدّاً، إلّا أنّ هذه الحالة من سوء الظنّ حرام قطعاً، ومن الكبائر، والتوبة منها واجب فوريّ، لأنّها تعني النفور منه تعالى، وبُغضه، والاعتراض عليه، والتمرّد على طاعته، وعدم الانقياد له على حدّ سواء. وبعبارة أخرى: حالة سوء الظنّ بالله ضدّ الإيمان.
*مقتبس من كتاب: القلب السليم، الشهيد دستغيب، ج 2، ص 279–291.